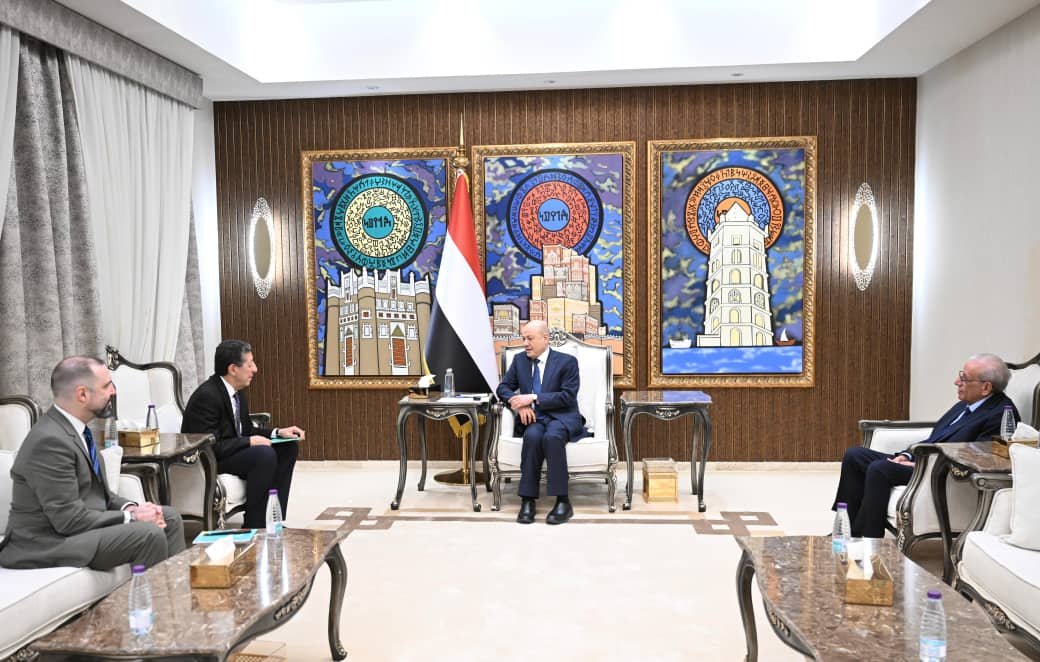“يمانيون في المنفى”.. قصص يمنيين في الاغتراب والمهجر

تقرير خاص
نظر “خليل” إلى بيته المتصدع الذي كان يوماً ما يحمل ذكريات طفولته، ونظر إلى أمه العجوز وهي تمسك بمسبحتها، تردد دعاءً خفيفاً كأنه حشرجة أخيرة: “ربنا يفرجها”، لقد سمع هذا الدعاء من امه لسنوات ولكن الفرج لم يأت، جاء الحوثي، جاءت المجاعة، وجاءت الأمراض والحروب، وجاء الموت يخطف الجيران واحداً تلو الآخر، قرر خليل أخيرا أن يهرب إلى وطن اخر، ترك اليمن بلد الأحلام المدمرة وحمل حقيبة صغيرة فيها صور أهله وقليل من المال، ومضى إلى تركيا ظناً منه أنها ستنقذه ,لكن تركيا لم تكن المنقذ.. بل كانت محطة جديدة من المعاناة.
الواقع المر
في الأسبوع الأول من الغربة كابوساً ثقيلا، نزل خليل في فندق رخيص بحي الفاتح بإسطنبول واكتشف أن سعر الغرفة ارتفع عندما سمعوا لكنته العربية، وان الشرطة توقف العرب في الشارع دون سبب، والاصعب ان الوظائف الشريفة محجوزة للأتراك دون غيرهم.
وبعد يومين من البحث المضنى وجد نفسه يقف أمام مطعم يمني صغير، رائحة الفحم أعادته إلى صنعاء للحظة، دخل وكاد يبكي عندما سمع الأغنية اليمنية التي تخرج من مذياع قديم، صاحب المطعم كان رجلا خمسينيا من محافظة إب، نظر إليه وسأله: “جاوع؟” ثم قدم له طبقا من الارز والدجاج كانت أول وجبة دافئة يتناولها منذ وصوله.
أيام العرق والذل
عمل خليل في تنظيف شقق الأتراك وغسل الأرضيات، وفي احدى المرات بينما كانت تقف ربة المنزل الطاعنة في السن تراقبه كأنه لص، وفي يوم ما اتهمته العجوز التركية بسرقة مجوهراتها، لأنه لم ينفذ اوامرها ا بالسرعة المطلوبة.
انتقل بعدها خليل إلى ورشة إصلاح سيارات في منطقة “أمينونو”، كان ملاك الورشة يعاملونه بقسوة ويلقون عليه أصعب المهام ويستهزئون بلهجته لكنه صبر، لأنه بحاجه الـ 1500 ليرة تركية في الأسبوع ,وفي المساء، كان يكتب يومياته على هاتفه القديم قائلا “:
“اليوم رأيت حمامة تقف على حافة النافذة وتساءلت إن كانت قد أتت من اليمن، ترى هل تعبر الطيور تلك الحدود مثلنا؟ ام إنها ايضا تحتاج إلى تأشيرات؟”
تعرض خليل لسرقة هاتفه وحقيبته الصغيرة، بكى بحرقة ليس على المفقودات، بل على صور عائلته التي كانت فيها، وفي اليوم التالي اضطر لبيع ساعته الوحيدة (هدية تخرج أخيه الأكبر) ليزور عيادة الاسنان التي كانت تؤلمه بشدة، وفي العيادة قابل طبيباً يمنياً” والذي قال له كأنه يواسيه “كنت أستاذا جراحة بجامعة صنعاء. لكن الحوثيين قطعوا راتبي ودمروا حياتي فركبت القارب انا واسرتي وطلبت اللجوء”، ضحكا معاً لكن عيونهما كانتا على وشك ان تفيضا بالدموع.
بعد ثلاث سنوات من الغربة والذل، قرر خليل العودة ولم يكن القرار سهلاً توفيت أمه وهو في الغربة ولم يعرف إلا بعد شهرين، تزوجت أخته الصغرى من رجل يكبرها بعشرين عاما.
وفي صنعاء شعر برائحة الدخان والتراب تدخل أنفه، “رائحة الوطن” قالها بصوت عالٍ، فالتفت إليه رجال الأمن الحوثيين بشراسة وظلوا يتفحصونه وكأنه زائر ثقيل غير مرحب به، وفي الطريق لمنزله رأى كل شيء قد تغير، الشجرة التي كان يتسلقها صبياً قطعها الجيران لتصبح حطباً ، ومدرسته الثانوية صارت ثكنة عسكرية، والمقهى الذي كان ملتقى الأصدقاء اغلقه صاحبه بعد ان تدهورت احواله الاقتصادية واصبح مفلساً كل شي اصبح قاتم اسود بلا امل.
قصص لا تروى
محمد ذلك الشاب من تعز الطموح الذي حلم بارتداء المعطف الأبيض وعلاج المرضى في مستشفى الجمهورية لكن الحرب سرقت منه حلمه ودمرت حتى الجامعة التي كان يدرس فيها، حاول الهرب إلى السعودية أولاً، لكنه فشل، ثم وصل إلى تركيا بعد رحلة شاقة عبر القوارب والحدود المغلقة.
في إسطنبول، قدم أوراقه للاعتراف بشهادته لكنه اكتشف أن عليه إعادة دراسة الطب كاملاً باللغة التركية وهو ما لم يستطع تحمله، بدأ يعمل في ورشة حدادة في منطقة “أوسكودار”، ومع الوقت صارت يديه الناعمتين التي كانت تمسك بالمباضع الطبية خشنة ومليئة بالجروح، وفي الليل كان يفتح كتبه القديمة ويقرأ فيها الكتب الطبية بصوت خافت، وكأنه يحاول أن يثبت لنفسه أنه ما زال ذلك الطالب الذي كان، وبعد شهرين أغلق محمد الكتاب الذي كان يقرأه، ولم يفتحه مرة أخرى ابدا.
الأم التي فقدت كل شيء
فاطمة كذلك لم تكن تعرف شيئاً عن تركيا إلا أنها بلد بعيد وآمن، عندما مات زوجها الذي كان مقاتلا في صفوف الحوثيين ، أخذت أولادها الثلاثة وهربت عبر البحر في قارب متهالك، كانت تخاف من الغرق، لكنها كانت تخاف أكثر من أن تبقى في اليمن حيث الموت قتلا او جوعا ينتظرهم كل لحظة ,في إزمير، وجدت نفسها وحيدة في غرفة صغيرة, عملت في تنظيف المنازل مقابل أجر زهيد، وأطفالها لم يذهبوا الي المدرسة لأنها لا تملك أوراقهم الثبوتية، وفي أحد الأيام مرض ابنها الصغير “صلاح” بحمى شديدة لكنها لم تكن تملك ثمن العلاج فاتصلت بكل الأرقام التي جمعتها من الجمعيات الخيرية ولم يجبها احد.
بكيت ليلتها بحرقه وهي تحتضن طفلها الذي يحترق من الحمى، حتى جاء جارها السوري وأعطاها دواء من الصيدلية، في تلك الليلة أدركت فاطمة أن الغربة لا ترحم أحداً، وأنها لو عادت إلى اليمن ربما ستموت بسرعة، لكنها بالغربة تموت كل يوم.
المتسول
على من صنعاء، كان يملك محلاً للعطور ويعرف كل زبائنه بالاسم، يفتح محله كل صباح ويستقبل أصدقاءه، وعندما بدأت الخسائر تتوالى عل محله بسبب الحرب حاول أن يبدأ من جديد في الحديدة فخسر كل ما تبقى معه، لذلك قرر الذهاب إلى تركيا وهناك بدأ بتجارة صغيرة يبيع العطور في الشوارع إلا أن الشرطة اخذت تطارده لأنه لا يملك تصريح عمل، وفي أحد الأيام صادرت كل بضاعته وهددته بالسجن، ولم يعد يملك حتى المال لشراء بضاعة جديدة.
والان علي أحد الجسور يعيش متجولا في المدن التركية يمد يده للمارة، بعضهم يعطيه النقود، والبعض الآخر ينظر إليه بشفقة أو ازدراء، وفي جيبه يحتفظ بزجاجة عطر صغيرة آخر ما تبقى من متجره القديم، يفتحها أحياناً ويشم رائحتها، وكأنه يريد أن يتأكد أن تلك الحياة الجميلة كانت حقيقية وليست حلماً.
انكسار وشتات
تشير التقديرات إلى أن أكثر من مئة ألف يمني يعيشون في دول أوروبا، يحملون في حقائبهم جراح الحرب وهموم اللجوء، ففي ألمانيا وحدها يقبع نحو ثلاثين ألف يمني، نصفهم تقريباً بدون أوراق ثبوتية نظامية، ويعملون في الظل بأجور هزيلة لا تتجاوز خمسة يورو في اليوم أحياناً، بينما يعاني ثلثاهم من صعوبات اللغة والعزلة القاتلة، وفي السويد حيث البرد القارس يعيش حوالي عشرة آلاف يمني أكثر من نصفهم من الأطفال والنساء، وكثيرون منهم لم يدمجوا بعد في المدارس بسبب عوائق القانون، وفي الدنمارك التي تشترط إتقان اللغة للبقاء، يخاف المئات من الترحيل كل يوم إذ تُرفض نحو أربعين بالمئة من طلبات اللجوء اليمنية هناك، أما في هولندا وبلجيكا، فيعمل الشباب اليمني في المزارع والمصانع تحت ظروف قاسية، حيث تقول التقارير” إن سبعين بالمئة منهم يعانون من أمراض نفسية بسبب صدمات الحرب والغربة، ووراء هذه الأرقام قصص لأناس يحملون أوجاع اليمن في عيونهم، يعيشون على هامش الحياة في أوروبا ويحلمون بالعودة، لكن الحرب واهوال الانقلاب لا يزالان ينتظرانهم هناك.
وطن لم يعد وطنا
قصص الغربه اختزلتها المعاناة كقصه خليل والذي يعيش بغرفة مستأجرة بحي شعبي يحاول أن يعيد بناء حياته من الصفر، و في جيبه يحتفظ بالعلبة المعدنية والتي تحتوي على تراب منزله القديم، يفتحها ويشم رائحتها و يغلق عينيه ويتخيل أمه في المطبخ القديم تعد الطعام , وأبوه في زاويه المنزل يقرأ القرآن وإخوته يلعبون في الحديقة الصغيرة، ويفتح عينيه ليجد نفسه وحيداً في غرفة مظلمة، صوت قذائف الطائرات يهز النوافذ، ورائحة البارود تملأ الهواء، في الغربة كان غريباً، وفي وطنه صار غريباً ينتظر الموت